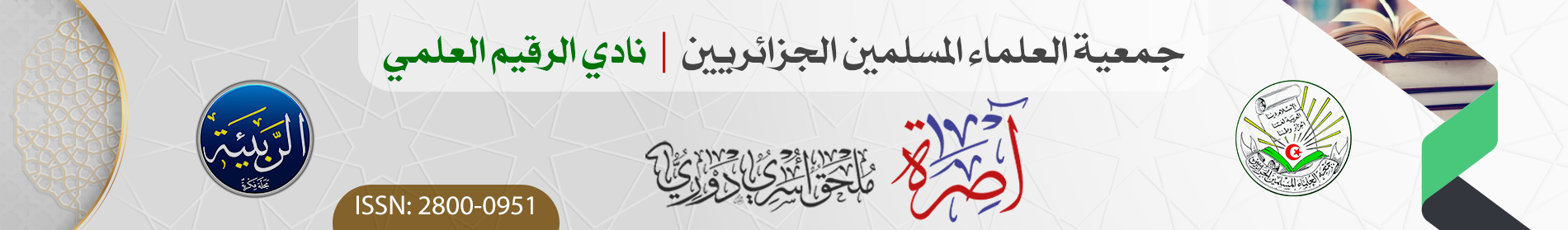الرهاب الاجتماعي (الفوبيا المجتمعية) أسبابها وطرق علاجها
د. سامية جبارة
كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة1.
تمهيد
استجدت في هذا العصر ظواهر وسلوكات في المجتمعات المختلفة، لم تكن في السابق، وظهرت مشكلات وآفات وأمراض لم نكن نسمع عنها في عصر أجدادنا، وليس من الضروري إبداء الحيرة والاستغراب، فمتطلبات هذا العصر في تجدد وتغير، وتداخل العوامل المختلفة في حياة البشر أفرز لنا سلوكات وظواهر وحالات أشبه بذلك، يمكن أن نُطلق عليها اسم الآفات أو الأمراض الاجتماعية، إذ تفشت هذه الأخيرة في كل المجتمعات، ولا بد من دق ناقوس الخطر والبحث عن أسبابها وضرورة إيجاد طرق الوقاية منها أو معالجتها.
الفوبيا المجتمعية، أو الرهاب المجتمعي هو أحد هذه الأمراض النفسية التي ظهرت في أوساط الأطفال وحتى عند الشباب، هذه الظاهرة كانت نادرة الظهور، أو ربما لم يتم تشخيصها للجهل بها من جهة، أو للتحفظ عليها من بعض المصابين بها أو أحد القائمين عليهم من جهة أخرى.
فما هي فوبيا المجتمع أو ما يسمى بالرهاب المجتمعي؟ وما أسبابها ومخاطرها؟ وكيف يمكن معالجتها والتخفيف من انتشارها بين أفراد المجتمع الواحد؟ هذا ما سنتطرق إليه من خلال هذه المقالة، للتعرف أكثر على الشريحة المستهدفة من هذا المرض النفسي الاجتماعي، والأسباب المؤدية إليه، ومظاهره وأشكاله.
تأتي هذه الدراسة انطلاقا من الملاحظة العميقة لنا لبعض الحالات التي نصادفها في محيطنا القريب والبعيد، ولبعض الحالات الخاصة في بيئتنا، ومن الظواهر التي لاحظناها في بعض المؤسسات التربوية التعليمية بحكم خبرتنا السابقة في التعليم الابتدائي والثانوي؛ لفئة من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة بعض السلوكات التي تصدر عن بعض الأفراد من المجتمع الواحد مما يُوّلِد مشكلات، ويخلق أمراضا نفسية تتطور مع مرور الوقت، وتكبر مع أصحابها، وقد لا ينتبه لها بعض الأولياء، أو يجهلون ماهيتها، ويتأخرون في الاهتمام بها مما يصعب علاجها، وهذا ينتج عنه فئة من أفراد المجتمع معاقة نفسيا وسلوكيا إن صح التعبير، فئة لا تساهم في بناء مجتمعها ورقيه، وتصبح عالة عليه.
بداية سنحاول التعرف على ظاهرة أو مرض الرهاب الاجتماعي (أو فوبيا المجتمع)، ثم نلقي الضوء على أسبابه وأعراضه، وعوامل تطوره لدى الأطفال والمراهقين وبعض الشباب بصفة عامة، وسبل الوقاية منه وعلاجه.
تعريف الرهاب الاجتماعي
الرهاب لغة: رهِب، يرهَبُ رهبة ورُهبا بالضم ورهَباً بالتحريك، أي خاف ، ورهِب الشيء رهبا ورَهَبا ورهْبة: خافه[1].
وجاء في معجم المعاني؛ رهاب (اسم)، جمع رُهابة، ورِهاب، جمع رَهب، رهِب الولد، خاف. ورهّب الولد، خوّفه وفزّعه والرّهبُ، الخوف.
ويقال: رُهاب الموت: خوف مرضي من الموت، ورلُهاب الاحتجاز: خوف مرضي نفسي من الوجود في الأماكن المغلقة أو الضيقة.
الرهاب الاجتماعي Social phobia: عرّفه [2]DSM-IV بأنه الخوف المبالغ فيه أو غير المبرر من المواقف الاجتماعية والتفاعل مع الأشخاص الآخرين خوفا من الانتقاد أو التدخل في الشؤون الشخصية[3].
فالرهاب هو خوف أو قلق من بعض المواقف الاجتماعية أو الأداء الاجتماعي، وغالبا ما يجري تجنب هذه المواقف أو تحمُّلها على حساب الكثير من الضيق والانزعاج.
ويؤكد بعض المختصين أنّ هذه الحالة أو المرض، نفسي وليس عضوي، ناتج عن عوامل وأسباب معينة، فغالبا ما ينتج عن تنمر بعض أطفال المدارس الابتدائي والمتوسط، بل حتى في مرحلة الثانوي على أطفال من نفس العمر، فيؤدي هذا التنمر إلى نتائج سلبية؛ من ذلك الانعزال والانسحاب الاجتماعي، وانخفاض في الأداء، إضافة إلى ما يعانونه من اضطهاد ومضايقة تدفعهم إلى قرار العزلة التامة عن المحيط التعليمي، بل من المجتمع ككل.
ولهذه السلوكات أسبابها ومظاهرها، وحاول بعض الخبراء النفسانيين والاجتماعيين التوصل إلى معرفة الأسباب والدوافع لإيجاد حلول أو علاج للحد من هذه السلوكات غير المرغوب فيها، والتي تنتج عادة من تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وأيضا بعض الأحداث الحاصلة نتيجة التطور التكنولوجي المذهل من جهة وما تشهده المجتمعات من صعوبة الحياة من جهة ثانية[4].
وقبل التغلغل في الموضوع، يمكننا القول أنّ الرهاب كمفهوم يدُّل على الخوف والفزع، هو صفة أو هو حالة انفعالية طبيعية تشعر بها كل الكائنات الحيّة على وجه هذه الأرض، وكلما كان هذا الخوف في حدوده المعقولة كان الشخص سويا من حيث انفعالاته وسلوكاته، والعكس صحيح؛ فكلما كانت درجة الخوف كبيرة ومتفاوتة بل متطرفة تعذّر معها السيطرة على الانفعالات وردود الأفعال، وبالتالي يصعب التحكم فيها وتُفسّر الحالة المرضية على أنّها نوع من الاضطراب النفسي الذي يصعب التحكم فيه وتنتج عنه سلوكات وردود أفعال غير سوية بهدف البعد عن مصدر ذلك الخوف.
تشير بعض الأبحاث والدراسات الميدانية على أنّ الرهاب الاجتماعي يبدأ في مرحلة الطفولة أو المراهقة، وقد يستمر مع الأشخاص إلى سنوات متقدمة من أعمارهم وهنا تكمن خطورته.
وتوصلت الإحصائيات بحسب الدراسات إلى أنّ نسبة (5.3) مليون فرد أمريكي يعانون من اضطراب الرهاب الاجتماعي، وأنّ هذا الاضطراب ينتشر أكثر بين المراهقين بين سن 15 و20 سنة، وينتشر بين الإناث أكثر منه عند الذكور، وأنّه انتشر في عالمنا العربي بنسبة( 8-10% ) ونفس الأمر بالنسبة للإناث أكثر انتشارا من الذكور وقد وصل هذا الرهاب حتى عند الشباب الجامعي التي وصلت نسبته إلى 9.3% [5].
حقيقة الرهاب الاجتماعي
اختلفت التفسيرات والنظريات في تحديد تفسير لحالة الاضطراب النفسي التي يمرُّ بها بعض الأشخاص وما يُطلق عليها بالرهاب الاجتماعي، فمنهم من يفسر ذلك على أساس أنّها استعدادات وراثية، أي أنّ الذين يعانون من الاضطراب والقلق الاجتماعي قد ورثوه من أسلافهم أو عائلاتهم، بينما هناك من يفسر هذه الظاهرة على أنّها مكتسبة من خلال التجارب والخبرات المؤلمة التي مرّ بها الأشخاص، وهناك من يرجعها إلى الجوانب المعرفية والمعتقدات المشوَّهة التي يتمتع بها الأشخاص المصابين بهذا الرهاب[6].
وهناك تفسيرات بيولوجية لهذه الظاهرة متعلقة بإفراز الجسم لبعض المواد التي تسبب حالة القلق والاضطراب عند الإنسان، وأخرى تحليلية نفسية تُرجع حقيقة الرهاب الاجتماعي إلى حالة الصراع النفسي الذي يعيشه الإنسان بينه وبين نفسه، وبينه وبين العالم الخارجي[7]، وبالتالي يجد نفسه أمام تحد كبير لمواجهة الظروف التي تعترضه ولا يتغلب عليها بسبب الخوف الذي يتملكه، كما أنّ هناك تفسيرات ونظريات عديدة لهذه الظاهرة، ولكنّ المقام لا يتسع للغوص فيها بقدر ما يتطلب منا هذا البحث التطرق للأسباب المؤدية إلى هذه الحالات الاضطرابية، ومعرفة وسائل علاجها أو التخفيف منها على الأقل، وقبل التطرق لأسباب الرُّهاب الاجتماعي، وجب معرفة الأعراض التي تشير إلى أنّ الشخص يعاني منه.
أعراض الرهاب الاجتماعي
قد تبدو على المريض بالرهاب الاجتماعي أعراض داخلية وأخرى خارجية، قد ينعكس بعضها أو أغلبها على مظهره الخارجي، فيمارس سلوكات أو تصرفات تلفت الانتباه لكونها غير طبيعية؛ ومن هذه الأعراض:
- القلق والتوتر البالغ الذي تصحبه بعض الحركات اللاإرادية ينتج عنها البعد والانعزال عن الآخرين.
- عدم الشعور بالراحة الداخلية في موقف معين، مما ينتج عنه بعض التوتر المصاحب لبعض الانفعالات كالخجل مثلا، واحمرار الوجه.
- الارتباك عند الحديث أو عند إبداء رأي، وظهور بعض التأتأة والارتجاف في الصوت، الذي يتبعه صمت كلي.
- ظهور بعض القلق والخوف عند المبادرة في الكلام أو حتى إلقاء التحية والسلام على الآخرين.
- تجنب المواقف الاجتماعية والدخول في أي نوع من الجدال أو النقاش في أي موضوع.
- الاتصال المباشر بأحد المقربين في كل المواقف والمناسبات، وعدم مفارقته له أبدا، مما يدل على ضعف في الشخصية وعدم الثقة في النفس.
- الشعور بالخجل والإحراج أمام الآخرين، كالأكل بأريحية، أو الدخول على مجموعة من الأشخاص في مكان عام، أو حضور المناسبات والحفلات التي تزدحم بالنّاس.. إلخ.
- محاولة التخفي عن الأنظار وعدم الظهور بين النّاس خاصة في المناسبات العامة.
أسباب الرهاب الاجتماعي
إنَّ الدراسات الميدانية والنفسية بخاصة والاجتماعية بيَّنت أسباب هذا الرهاب الاجتماعي وكيف تؤثر على الحالات المصابة به، ومن هذه الأسباب ما هو داخلي يعود إلى العامل الوراثي ومنها ما هو خارجي مكتسب، ولكن ليس من الواضح تمامًا مقدار ما يكون ناتجًا منها عن عوامل وراثية ومقدار ما يكون منها سلوكًا مكتسبًا.
أولا/ الأسباب الداخلية (وراثية/ عضوية):
يغلب على اضطرابات القلق أو الرهاب الاجتماعي أن تكون متوارثة في العائلات، فتزداد احتمالية الإصابة باضطراب القلق الاجتماعي إذا كان أحد الوالدين أو أشقاؤهما مصابين بهذه الحالة، فالوالدين ينقلان للأبناء كل السلوكات؛ إما عن طريق الوراثة أو عن طريق المعاملة، فهذه من أهم الأسباب التي يبدأ منها القلق والرهاب الاجتماعي، في حين يمكن للأسباب العضوية أن تكون سببا للإصابة بالرهاب الاجتماعي أيضا، كأن تكون ” منطقة في الدماغ يُطلق عليها اللوزة قد تؤدي دورًا في التحكم في الاستجابة للخوف، وقد يكون لدى الأشخاص ذوي اللوزة مفرطة النشاط استجابة عالية للخوف، ما يسبب زيادة القلق في المواقف الاجتماعية”[8]، ويعتقد أن من أسباب الإصابة بالرهاب الاجتماعي أيضًا وجود خلل في توازن بعض النواقل العصبية في المخ التي لها دور في استقرار الحالة المزاجية، مثل الدوبامين، والسيروتونين، والغلوتامات[9].
ثانيا/ الأسباب الخارجية (المكتسبة):
قد يكون اضطراب القلق الاجتماعي سلوكًا مكتسبًا، فالبعض قد يُصاب بقلق بالغ بعد موقف اجتماعي غير سار أو محرج، ربما يكون هناك أيضًا ارتباط بين اضطراب القلق الاجتماعي وبين الآباء والأمهات الذين تبدو عليهم سلوكيات قلقة في المواقف الاجتماعية أو أكثر سيطرة أو حرصًا على أطفالهم[10] وهذا مردُّه التنشئة الأسرية، ويمكن تلخيص هذه الأسباب فيما يلي:
– المرور بأحداث مؤلمة وصادمة، كوفاة شخص عزيز، أو التعرض للإهانة الشديدة من طرف أحدهم، أو الاعتداء والإهمال، وأهم هذه الأسباب هو التعرض للتنمر.
– المشاكل الأسرية، سواء بين أفراد العائلات، أو بين الوالدين نتيجة طلاق أو لكثرة الاختلافات.
– العقد الناتجة عن عاهة ما أو مرض مزمن.
– مبالغة الآباء في تربية الأبناء، سواء بالمبالغة في حمايتهم، أو حب التحكم فيهم.
– الفراغ الكبير الذي يعيشه الأبناء، إما لانشغال الأولياء الدائم عنهم بسبب العمل أو بسبب انفصالهم عن أحد الوالدين، فيجد الأبناء أنفسهم في حالة من الضياع يدفعهم لممارسة مختلف السلوكات غير المرغوبة، ومنها الاختفاء عن الأنظار واختيار العزلة.
ولعل أهم سبب يؤثر في ارتفاع نسبة الإصابة بالرهاب الاجتماعي هو التنمر المدرسي، والتربية الخاطئة من قبل الأولياء.
1/ التنمر المدرسي
التنمُّر: وجاءت هذه الكلمة في القواميس اللغوية كمعجم المعاني بمعنى: تنمّر، أي تشبَّه بالنمر في لونه أو طبعه، ويُقال: تنمّر لفلان: تنكَّر له وأوعده، وتنمّر مدّد في صوته عند الوعيد.
وجاء في لسان العرب لابن منظور، فمعنى التنمُّر: سوء الخلق: ونمًّر وتَنَمَّر، ونمّر وجهه أي غيره وعبسه[11].
والتّنمُّر ظاهرة قديمة وُجِدت في جميع المجتمعات، ويعني الاستقواء ويتشكل عند الإنسان في مرحلة مبكرة من الطفولة، والاستقواء سلوك مكتسب من البيئة التي يوجد فيها الشخص، ومن خلال هذا السلوك تُمارَس مجموعة من السلوكات المؤذية من طرف المستقوي أو المتنمِّر قد يكون أذى نفسي وجسدي وجنسي أيضا، تجاه فرد أضعف منه في القدرات الجسمية أو العقلية، فالتنمُّر هو إيقاع الأذى على فرد بدنيا أو نفسيا أو عاطفيا أو لفظيا، وقد يتضمن التهديد بالأذى البدني أو الجسمي بالسلاح والابتزاز إلخ [12].
أغلب ممارسات الاستقواء الناتجة عن هذا التنمر تحدث في المؤسسات التعليمية، وتحدث أيضا في مراكز الإصلاح، وأيضا في بعض الجامعات وأماكن العمل، وهذا النوع من السلوكات لها تأثير كبير على الشخص ومن أهم هذه التأثيرات:
- عدم الرغبة في مزاولة الدراسة؛ خاصة إذا كان التنمر صادرا من زملائه في المدرسة وناتج عن سخريتهم منه.
- الإصابة بحالة من الاكتئاب الشديد بالميل إلى الانطواء واختيار العزلة عن الناس.
- الشعور بعدم الرضى عن الشكل الخارجي له، وعدم الثقة في النفس والتذمر منها.
- فقدان الأمل في كل من حوله من العالم الخارجي، وعدم الرغبة في الاحتكاك بأي شخص.
- اتساع دائرة التفكير السلبي عنده قد يصل به الأمر إلى درجة التفكير في الانتحار.
ومن نتائج التنمر:
- التأثير على الحياة الشخصية والاجتماعية للشخص.
- صعوبة تكوين علاقات اجتماعية.
- التفكير السلبي المستمر وعدم الثقة في النفس.
- تفضيل العزلة وعدم الاحتكاك بالآخرين وقطع التواصل مع الأصدقاء.
- الاعتكاف في غرفة خاصة به في المنزل والسهر المطول، المؤدي غالبا إلى حالة سيئة قد تصل عند البعض ربما إلى إدمان الخمر أو المخدرات.
- الاضطراب والتوتر بين أفراد الأسرة، واختلال توازن المعيشة بينهم.
2/ التنشئة الأسرية الخاطئة
لا شك أنّ للأسرة دور كبير في ما يؤول إليه الأبناء بدرجة كبيرة، وأهم الأسباب المساعدة على إصابتهم بالقلق أو الرهاب الاجتماعي ما يلي:
- انعدام الحوار والتواصل الرشيد بين الأولياء والأبناء؛ ومن ذلك عدم سماع ما يرغبون فيه، أو عدم ترك مجال للتعبير عن آرائهم وطرح انشغالاتهم.
- الفجوة بين الأب وابنه، وبين الأم وابنتها، من شأنه أن يدفع بأحدهما إلى البحث بعيدا عن بديل للاهتمام بهما، وهو ما يدفع باحتمال الوقوع بين يدي أشخاص غير مؤهلين لذلك.
- حب السيطرة من طرف الأب أو الأم أحيانا، تجعل من الأبناء ينصاعون للأوامر دون اعتراض، وهو الأمر الذي يجعل الأبناء يتصفون بضعف في الشخصية، وسهولة النيل منهم في العالم الخارجي.
- سخرية الوالدين أو أحدهما من الأبناء وأسلوب المقارنات، مما يزعزع الثقة في نفوسهم، واهتزاز الشخصية لديهم.
- انعدام الرقابة الأسرية المطلوبة، وهو ما يزيد في انطواء الأبناء بالتدريج إلى أن يصابوا بالرهاب الاجتماعي في غياب هذه الرقابة والمتابعة من قبل الوالدين.
- الدلال المفرط للأبناء قد يخلق منهم أشخاصا اتكاليين وضعفاء الشخصية.
- جهل الأسرة بحقيقة الرهاب الاجتماعي ومدى خطورته على الشخص، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة في بداية الإصابة به.
- الخلافات المستمرة بين الوالدين أمام الأبناء تترك أثرا في نفوسهم يتطور مع مرور الزمن حتى يصل إلى درجة الاحباط ثم النفور من الواقع وتصور خاطئ عن الحياة والعلاقات الإنسانية.
- عدم التواصل المستمر بين بعض الأولياء والمؤسسات التعليمية في إطار المتابعة المفروضة عليهم، لمعرفة ما يحدث مع الأبناء وزملائهم ومدرسيهم.
- رفض فكرة العلاج النفسي عند بعض الأولياء لعدم الاقتناع أو بسبب أفكار وعادات اجتماعية بالية، مما يعطل العلاج المبكر لحالات الرهاب الاجتماعي للأبناء.
- غياب الوعي والثقافة المطلوبة عند الوالدين في كيفية التعامل مع حالات الرهاب الاجتماعي وعلاجه في بداياته، مما قد يزيد في حدة الإصابة ومضاعفتها.
أهم الحلول و المقترحات
الرهاب الاجتماعي مرض خطير، وتكمن خطورته في انتشاره السريع بين صفوف الأطفال والشباب، وللعمل على الحد والتخفيف منه، وجب اتخاذ بعض التدابير والحلول بحسب حالة كل واحد ودرجة تطورها ومن هذه الحلول نقترح ما يلي:
- توعية الأولياء والتنبه لمدى خطورة هذه الظاهرة، وعليهم إدراك مدى خطورتها على الأبناء وعلى المجتمعات.
- إدراك الوالدين بأهمية التعامل مع الأبناء في كل مراحلهم العمرية، وخلق جو من الحوار البنَّاء والمجدي، دون التحيز للرأي وفرض السيطرة.
- على الوالدين متابعة أبنائهم والاهتمام المستمر بهم وبانشغالاتهم اليومية وبأصدقائهم.
- المرونة في التعامل والتربية الصحيحة التي تستند إلى المرجعية الدينية، هي أساس الصلاح والفلاح.
- توعية شاملة وتحسيسية في كل المؤسسات التعليمية، للتنبيه على وجوب الالتزام ببعض السلوكات الإيجابية في التعامل بين المتمدرسين، والحذر من ممارسة بعض السلوكات السلبية من طرف البعض الآخر، وتوقيع أقصى العقوبات لمن خالفها.
- وضع حد لحالة التنمر الموجودة خاصة في المؤسسات التعليمية، ومتابعة المتنمرين، وتوعيتهم بعواقب سلوكهم الاستقوائي على زملائهم.
- المسارعة في تقديم المساعدة المبكرة، لأنه قد يصعب علاجها في حال تأخرت الحالة.
- مشاركة بعض المصابين بالرهاب الاجتماعي وتبادل الأفكار والتجارب معهم في جلسات خاصة.
- ممارسة الأنشطة المهمة والمتنوعة كالرياضة أو الرسم، ومحاولة تغليب التفكير الإيجابي على السلبي بمساعدة متخصصين نفسانيين واجتماعيين.
- مساعدتهم على وضع برنامج يومي، تتخلله فترات راحة ونوم، وترتيب الأولويات.
- تخصيص الأولياء الوقت الكافي للأبناء، وإشعارهم بأهميتهم في حياتهم، من شأن هذا تعزيز الثقة في نفوسهم، وإعادة إدماجهم في الأسرة ثم في المجتمع.
خاتمة
في الأخير يمكننا القول أنّ الرهاب الاجتماعي أو فوبيا المجتمع، هي ظاهرة مستفحلة في مجتمعاتنا، ومنتشرة بكثرة في صفوف الأبناء والبنات ما بين سن المراهقة والشباب، وقد تعود هذه الظاهرة إلى أسباب كثيرة ومتباينة قد تكون وراثية وقد تكون مكتسبة، وأهمها برأينا يعود إلى التنشئة الأسرية التي تخلق شخصا معاقا سلوكيا ومعاقا فكريا ومعاقا مجتمعيا.
فالأسرة التي ينشأ فيها ابن ضعيف الشخصية نتيجة لعوامل معينة في الأسرة، يصعب عليه مواجهة العالم الخارجي أو المحيط الذي يتواجد فيه، وبالتالي يكون أكثر عرضة للتنمر أو لأمور أخرى تدفعه إلى نبذ واقعه ورفضه، واختيار العزلة كحل للهروب منه، عجزه عن الدفاع عن نفسه، أو إثبات وجوده وإظهار قدراته .
الأسرة مسؤولة بالدرجة الأولى عن وصول هؤلاء الأبناء إلى حالة من الاضطراب والقلق الاجتماعي، بسبب سوء التوجيه، وغياب الحوار والمتابعة والرقابة الأبوية، والإفراط والتفريط بين الشدة واللين في التعامل معهم.
المجتمع عامل آخر في تطور ظاهرة الرهاب عند الأشخاص، وذلك بوجود فئة مستقوية متنمرة، تفتقد لأدنى شروط التحضر والتخلق بأخلاق الإسلام، وهذه الفئة هي صناعة الأسرة أيضا، قد تعود نشأتها إلى خلفيات وأوضاع أسرية غرست في نفوس أبنائها نوع من الغرور والاستقواء أو تربت على شيء من الكبر والتعالي، فأنتجت أشخاصا لا يحترمون الآخرين، ويتنمرون عليهم، وقد يتوصل بهم إلى حد الاعتداء عليهم بكل أنواع الاعتداء.
ولمواجهة مثل هذه الحالات سواء حالة المصابين بالرهاب الاجتماعي أو القائمين بالتنمر عليهم، لابد من مراجعة طرق التربية الأسرية، والرجوع إلى ما حثت عليه الشريعة الإسلامية، وما نص عليه الكتاب المبين، والسنة المطهرة، فقد خلق الله تعالى الخلق في أحسن تقويم، على الفطرة النقية الخالية من ذميم العادات، وكلُّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا أسلم لهم من اتباع الهدي النبوي في طرق التربية والتعامل مع الأبناء لتجنب كل الآفات والظواهر السلبية في المجتمعات، مصداقا لقوله صلى الله عليه: ” تركتُ فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم”.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين.
[1] – محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، (بيروت: دار الضياء، ط1).
[2] – DSM-IV : وتعني بالفرنسية، Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux وتعني؛ الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، صادر بواشنطن الطبعة الرابعة، 1995.
[3] – بشار زيدان محمد، الرهاب الاجتماعي وعلاقته بالأفكار اللاعقلانية لدى طلبة المرحلة الثانوية في ضوء نظرية ألبرت أليس”، رسالة ماجيستير، جامعة عمان (الأردن)، 2013، ص9.
[4] – بشار زيدان محمد، المرجع السابق، ص12.
[5] – المرجع نفسه.
[6] – أمينة غرزولي، منال مداوي، فعالية تقنية الاسترخاء لجاكبسون في التخفيف من أعراض الرهاب الاجتماعي(دراسة ميدانية بالعيادة بأم البواقي ومركز التنمية البشرية بعين البيضاء)ـ، رسالة مكملة لنيل شهادة الماستر، جامعة أم البواقي، الجزائر، 2021).ص 74.
[7] – المرجع نفسه.
[8] – اضطراب القلق الاجتماعي(الرهاب الاجتماعي)، مأخوذ من مقال من إعداد فريق مايو كلينيك، شوهد بتاريخ: 26/03/2023. الموقع: https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/social-anxiety-disorder/symptoms-causes/syc-20353561.
[9] – موقع social phobia https://altibbi.com/.
[10] – اضطراب القلق الاجتماعي(الرهاب الاجتماعي)، المرجع السابق.
[11] – ا بن منظور، لسان العرب، ص235/5.
[12] – علي موسى الصبحين، محمد فرحاة القضاة، سلوك التنمر عند الأطفال والمراهقين(مفهومه-أسبابه-علاجه)، الرياض، ط1، 2013م، ص7.