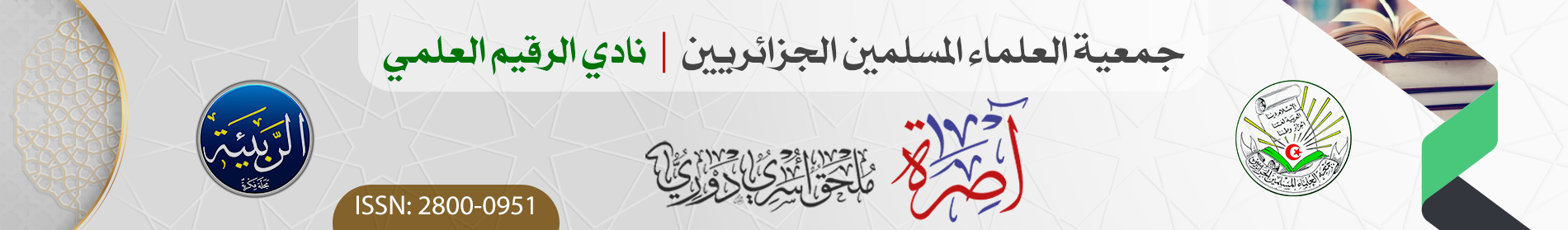الوقف على الأرملة واليتيم في الحضارة الإسلامية وسبل تفعيله في حياتنا المعاصرة-أ.د. حياة عبيد-الجزائر-
مقال بعنوان: الوقف على الأرملة واليتيم في الحضارة الإسلامية
وسبل تفعيله في حياتنا المعاصرة
أ.د. حياة عبيد، أستاذ التعليم العالي
بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الوادي
باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
تُقاس قوة المجتمعات بمدى تماسك نسيجها الاجتماعي، وتكافل وتضامن أفرادها، فلا ظلم ولا قهر ولا ذلّ يصيب أبناءها ومن يعيش في كنفها، أليس الظلم مؤذن بخراب العمران على رأي ابن خلدون[1]؛ كما أنّه لم يخل مجتمع إنساني من ضعفاء بشكل ما، قد يكونون فقراء أو أرامل أو أيتاما أو عجزة أو مرضى أو غير ذلك، فضعف هؤلاء هو امتحان لرحمة وتكفل أسرهم ، وهو امتحان لتكافل مجتمعهم بل هو امتحان لإنسانية البشر المحيطين بهم، فإن قدموا العون والسند فقد رَحموا ورُحموا، وإن تَخاذلوا فقد خُذلوا، وهو خذلان يتمظهر بتفكك المجتمع وسقوطه في هاوية الحقد والغضب والانتقام عاجلا أم آجلا.
لم يكن الضعفاء في المجتمع الإسلامي الحق عبئا ثقيلا، بل هم فرصة للنصر، الحقيقي على العدو، والمعنوي على أنانية الذات وقسوتها وحب الأثرة فيها، للسمو بها إلى الدرجات العلا من تزكية النفس ومرضاة الله عز وجل؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في معرض الاحتفاء بالضعفاء وعدم تحسيسهم بأنهم بلا جدوى، وتنبيه الأقوياء لمغبة احتقارهم والتكبر عليهم، وعدم جبر كسرهم وخواطرهم، والانزعاج منهم، إذ أنّ ضعفهم هو قوة لهم بها يتحقق نصرهم ” ابغوني ضُعَفاءَكم، فإنَّما تُرزَقونَ وتُنصَرونَ بضُعفائِكُم”[2].
الأرملة واليتيم من الضعفاء في المجتمع، فرعايتهما والسعي عليهما مما حث عليه التشريع الإسلامي، فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم رفيقه في الجنة في قوله عليه الصلاة والسلام ” وأنا وكافِلُ اليَتِيمِ في الجَنَّةِ هَكَذا وأَشارَ بالسَّبَّابَةِ والوُسْطَى، وفَرَّجَ بيْنَهُما شيئًا”[3]، كما حث على السعي على الأرملة، إذ قال عليه الصلاة والسلام “السَّاعِي علَى الأرْمَلَةِ والمِسْكِينِ، كالْمُجاهِدِ في سَبيلِ اللَّهِ، أَوْ: كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ “[4].
السعي على الأرملة سعي عليها وعلى أيتامها، فالسعي لهما وعليهما يعدل الجهاد وقيام الليل وصيام النهار، وليس ذلك بغريب، فالجهاد لصد العدو وحماية المجتمع من التقتيل والاعتداء على الدين والعرض والمال، وتحقيق للأمن الخارجي، فكيف يعدله السعي على الأرملة والمسكين؟ بلى، إنّه يعدله، لأنّ السعي عليهما وتلبية حاجاتهما المادية والمعنوية، تحقيق للأمن الداخلي، الأمن المجتمعي، ولا أمن لأي مجتمع مالم يتوفر الأمنان الخارجي والداخلي.
كيف استطاع المجتمع الإسلامي قديما إبان حضارته الزاهرة رعاية الأرامل والأيتام رعاية كاملة شاملة؟ الجواب في مقولة للعلامة الدهلوي إذ جاء في كتابه حجة الله البالغة:” ومن التبرعات الوقف .. فاستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيرا، ثم يفنى، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، ويجيء أقوام آخرون من الفقراء، فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء وأبناء السبيل تصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله على ملك الواقف”[5].
إذن كيف تكفل الوقف الإسلامي بسد الحاجات المادية والمعنوية للأرامل والأيتام؟ وكيف السبيل لتفعيل ذلك في حياتنا المعاصرة؟
لقد كان التكفل بالأرامل والأيتام يتم أولا في الأسرة الصغيرة أو الكبيرة، فالأسرة مؤسسة واحدة يتكافل أفرادها، ولكن قد تكون الأسرة الممتدة فقيرة وعاجزة، أو تصير الأرملة منقطعة لا قريب لها، والأيتام لا أم تعتني بهم ولا ذوو رحم يحتمون بهم، فهنا تقوم الأوقاف بدورها في التكفل بكل هؤلاء تكفلا جميلا جعل الوقف مأثرة الإسلام ومرحمة بين أهله.
وقبل تبيان أهم صور تكفل الوقف بالأرامل والأيتام لا بأس بتوضيح المقصود من الوقف، فالوقف أو الحبس هو:” تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة”[6]، وهو من القرب المشروعة بعموم الآيات التي تحض على البرّ والإحسان، والخير والتصدق والصدقات دون ذكر للوقف على التخصيص، ولما كان الوقف من الأعمال الخيرية ومن الإحسان، وهو صورة من صور الصدقات فإنّ هذه الآيات تشمله بشكل غير صريح، كقوله تعالى:﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة/280، وكذلك قوله تعالى:
﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ آل عمران/92.
أمّا السنة النبوية فقد صرحت بمشروعية الوقف، وأنّه من أجل القربات، فقوله عليه الصلاة والسلام:” “إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاث: إلاّ من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له”[7]. دليل على أن جريان الصدقة هو الوقف[8].
إن مقاصد الوقف تتمثل في كونه ينشأ بنية التقرب لله والاحتساب له، ولتحقيق مصالح عامة معتبرة اجتماعيا، وبآليات رشيدة إداريا واقتصاديا، تجعل العين الموقوفة مؤهلة لإعادة إنتاج المنافع واستدامتها[9].
المحور الأول: الوقف على الأرملة واليتيم في الحضارة الإسلامية:
وفيما يلي تفصيل لبعض صور الوقف على الأرملة واليتيم في تاريخ المسلمين :
أولا: الوقف الذري[10] أو الأهلي على الأرملة والأيتام من الأهل والأقارب:
الوقف الذري أو الأهلي أو الخاص هو الوقف الذي يُخصّص في ابتداء الأمر على نفس الواقف وعلى ذريته وأولاده، أو على أقاربه، وذريتهم وأولادهم أو على شخص معين أو أشخاص معينين ثم من بعدهم على جهة خيرية كالفقراء والمساكين والمساجد[11].
لقد ظهر الوقف الذري من قبل الصحابة رضوان الله عليهم في أقل من عشر سنوات بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم[12]، ومن الأوقاف الخاصة بالأرملة وأيتامها أو المطلقة وقف الزبير بن العوام، إذ حبس دوره على بنيه، وأنّ للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة، ولا مضرا بها، فإذا استغنت بزوج فليس لها حق[13].
ثانيا: استفادة الأرملة والأيتام من الأوقاف الخيرية العامة المرصودة لعامة المسلمين وفقرائهم:
تؤكد المصادر التي تناولت دراسة الوقف منذ نشأته، أنّ أغراضه ومصارفه كانت شديدة التنوع، وشاملة لأغلب مناحي الحياة الإنسانية، فقد تكفلت بإنشاء وتمويل الكثير من المؤسسات الخدمية والخدمات العامة، بل امتدت لخدمة أغراض الرفق بالحيوان ورعاية الطيور، وتجميل المحيط، وتوفير المنتزهات لعامة الناس، وغير ذلك من التحسينيات بعد سد الضروريات والحاجيات[14].
لذلك يعتبر نظام الوقف من أهم النظم الشرعية اللصيقة بالمسلمين، وأشدها تأثيرا في واقعهم ومستقبلهم، ” بل أصبح ضمانا لاستمرار مؤسسة الفقه ودور العبادة والعلم في تأدية الواجبات المنوطة بها..”[15].
وبنظرة فاحصة لمجالات مختلفة تكفل بها الوقف الإسلامي يمكننا الجزم أنّه استهدف تحقيق الكليات أو الضروريات الخمس التي لا تستمر حياة الإنسان بفقدانها، فها هي الأوقاف تقيم الدين وتحفظه، وترعى حياة الإنسان وتحفظ له نفسه، وعقله، ونسله وماله، بمستوياتها الضرورية والحاجية والتحسينية، وكل من يعيش في كنف الدولة الإسلامية يستفيد من خدمات الأوقاف مادامت عامة حسب ما قرره واقفوها، وهكذا كان للأرامل والأيتام نصيب منها مثل غيرهم، وفيما يأتي نماذج من تلك الأوقاف التي حفظت جميع المسلمين بما فيهم الأرامل والأيتام من الجوع والعري والتشرد، والجهل وسيء الأخلاق[16]:
1-الوقف على العبادات: وذلك كوقف المساجد التي كانت عبر التاريخ ولازالت منارات لنشر الدعوة وتعليم الناس وتربيتهم وتهذيبهم، وتزكيتهم روحيا وأخلاقيا، كما أسهمت الأوقاف في الحفاظ على الشعائر الدينية بتيسير أداء فريضة الحج، وعرفت المجتمعات الإسلامية أوقافا للتوسعة على المسلمين خاصة الفقراء في رمضان وعاشوراء ومختلف المواسم الدينية كالعيدين[17].
السؤال المطروح: ما هو أثر تلك الأوقاف على الأرامل والأيتام؟
تؤدي تلك العبادات المتنوعة بشكل فردي أو جماعي إلى تقوية إيمان الأرملة، وتزكية نفسها، فيثبت يقينها بأن قدر الله كله خير، وسيرفع الله شأنها إن هي صبرت واحتسبت، وأحسنت لنفسها وأولادها بأداء واجباتها المضاعفة بعد وفاة الزوج، ومن جهة أخرى فالعبادات وتزكية النفس تعين بقية أفراد المجتمع على احترام الأرملة، والسعي للقيام بحاجاتها وحاجات أيتامها، حسبة لله، ورغبة في الفوز بأجر الجهاد والقيام والصيام، وصحبة النبي المختار صلى الله عليه وسلم[18].
كما أن العبادات والدروس المسجدية تربي المسلمين على الإحسان، ومراقبة الله وخشيته فلا يعتدون على الأرامل والأيتام في عرضهم أو مالهم، لقوله تعالى:{ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} النساء/10.
2-الوقف للتكافل الأسري والاجتماعي: قامت الأوقاف بدور مهم في التآزر والتكافل الاجتماعيين من خلال صلة الأرحام بالإنفاق على القرابة من الأبناء والذرية من خلال الوقف الأهلي أو الذري. وكذلك رعاية الأيتام وأبناء السبيل وذوي العاهات من خلال الأوقاف الخيرية، كما عرفت المجتمعات الإسلامية أوقافا لافتكاك الأسرى، وأوقاف الإطعام والسقاية وأوقاف الكساء والأغطية لمن يحتاجونها، وأوقاف مساعدة المصابين والمنقطعين والغرباء[19].
3-الوقف على الرعاية الصحية: يُعدّ هذا الغرض من أوسع المجالات التي وقف المحبّسون أملاكهم عليها، وشملت أنواعا كثيرة مثل بناء البيمارستانات “المستشفيات والمصحات”، للعلاج ومنح الدواء مجانا، والبحث العلمي المرتبط بالمجالات الطبية، كالكيمياء والصيدلة[20].
ويظهر أثر تلك الاوقاف الصحية على الأرملة والأيتام بتمكينهم بكل يسر من الرعاية الصحية الجسدية، دون اغفال صحتهم العقلية والنفسية التي قد تتأثر بوفاة الأب السند والمعيل، والمنافح على أعراضهم وكرامتهم.
4-الوقف على التعليم ونشر الثقافة: تكفلت الأوقاف برعاية التعليم ونشر العلم من الكتاتيب إلى الجامعات والأكاديميات، ووفرت كلّ ما تحتاجه العملية التعليمية من وسائل وتجهيزات وأساتذة ومكتبات ومخابر ومراصد، ويكفي شاهدا على ذلك المدارس الوقفية المنتشرة في سائر أنحاء العالم الإسلامي، وكذا المساجد والجوامع التي أضحت منارات للعلم وفي مقدمتها الحرمان الشريفان، والأزهر الشريف في مصر، والقرويين في المغرب والزيتونة في تونس، والأمويين في دمشق. ناهيك عن المكتبات والمستشفيات الجامعية وغيرها[21].
ويتمثل أثر التعليم بتيسيره عن طريق الأوقاف العامة بتذليل الصعوبات المادية والاجتماعية والنفسية التي تضعف من حماس الأرملة وإرادتها في التعلم وتشجيع أيتامها على الترقي في مدارج العلماء، والتاريخ الإسلامي شاهد على نبوغ كثير من الأيتام في كثير من العلوم بفضل الأوقاف الخيرية على التعليم وتعميمه، ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري أئمة أعلام وقد كانوا أيتاما في كنف سيدات كريمات.
5-الوقف على تحقيق الأمن الخارجي (النواحي العسكرية والجهاد): أوقف الصحابة الكرام والتابعون، ومن تبعهم بإحسان من العلماء والحكام وذوي اليسار في الأمّة الأموال على سدّ الثغور، وإنشاء الرباطات للجنود، وتجهيز المجاهدين بالعتاد والأسلحة، وفكاك ومفاداة الأسرى، وذلك حماية للدين والأمة، وتحقيقا للأمن بكل أبعاده[22].
لقد كان لتوفر الأمن الخارجي للمجتمع الإسلامي دور كبير في استقرار الأرامل والأيتام، وذاك أمر مهم في تمتعهم بالأمن الأسري الذي هو أساس كل نبوغ وابداع.
6-الوقف على البنية التحتية: كالوقف على إنشاء الطرق، والجسور وآبار الشرب، والفنادق والخانات لتيسير الحج والتجارة، وغير ذلك من الخدمات العامة[23].
7-الوقف على التنمية الاقتصادية: أدت أوقاف الأعيان كالمباني والأراضي الزراعية، وأوقاف الآلات الزراعية وحيوانات الزراعة، والبذور للقرض والنقود للمضاربة أو الإقراض الحسن وغير ذلك من صنوف الوقوف التي عرفتها المجتمعات الإسلامية، دورا هامّا في التنمية الاقتصادية، والقضاء على البطالة، وتحسين المستوى المعيشي للأفراد والرقيّ الاقتصادي بالمجتمعات.[24]
ثالثا: نماذج من الوقف على الأرملة (والأيتام تبعا لأمهاتهم):
لقد أدرك المسلمون أن رعاية الأرملة والسعي لقضاء حوائجها هو تقوية لضعف في مجتمعهم، وسد لثغرة فيه قد تؤدي باستقراره وأمنه، وبناء على وصية رسولهم صلى الله عليه وسلم، فقد كانت صور رعايتهم للأرملة مبهرة وذات دلالات قيمية وأخلاقية تحتاج للدراسة والتحليل، ونورد نماذج من ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر.
1-إيواء الأرملة وتوفير السكن لها حفظا لعرضها وكرامتها: وهو أمر ضروري لأمنها واستقرارها، سواء كانت ذات أولاد أيتام، أو لم يكن لها أولاد، وهو وقف لا يُراد منه حفظ نفس الأرملة بتوفير المأوى والمأكل والمشرب والعلاج فقط، وإنما يراد منه أيضا صيانة عرضها وحفظ كرامتها هي وأولادها فلا يُهانون، ولا يريقون ماء وجوههم لأحد من الخلق.
ومثاله:
– اشترت عائشة دارا وحبستها على آل أبي بكر، وأسماء تصدقت بدارها صدقة حبس.[25]
ويُعدّ الصحابي الزبير بن العوَام أوَل من أوقف وقفا لصالح الأرامل والمطلقات من بناته، إذ جاء في صيغة وقفه لدوره”.. وللمردودة[26] من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرّ بها، فإذا استغنت بزوج فلاحق لها..”[27].
وجدت كذلك دور ورباطات[28] أقامتها الأوقاف لرعاية النساء المطلقات والأرامل، واللاتي هجرهن أزواجهن، وأُجريت عليهن الأرزاق من الأوقاف، فأم الخليفة الناصر العباسي أوقفت رباطا بمكة المكرمة عام 579هـ-1183م[29]، كما أصبحت الخانقوات[30] ملاجئ لأصحاب العاهات وكبار السن والعميان، فضلا عن المطلقات من النساء، وقد يكون من بينهن أرامل لا أهل لهن[31].
وأوقف إسماعيل رفعت عام 1867م ملجأ باب الخلق بمصر لصالح إنزال وإسكان عشرين امرأة من النساء والعجائز الفقيرات المسلمات، والعاجزات عن الكسب الخاليات من الأزواج[32].
2- توفير الغذاء والشراب والكساء والعلاج للأرملة وقضاء ديونها: فقد نصت وثيقة السلطان حسن لوقفه بأن يصرف ريعه في وجوه البرّ والقربات “كخلاص المسجونين، ووفاء دين المدينين، وفكاك أسرى المسلمين، وتجهيز من لم يؤد فرض الحج لقضاء فرضه، وتجهيز الطرحاء من أموات المسلمين وإطعام الطعام، وتسبيل الماء العذب، والصدقة على الفقراء والمساكين والأيتام، والأرامل والمنقطعين، والزمنى والعميان وأرباب العاهات، وذوي الحاجات من أرباب البيوت وأبناء السبيل، على ما يراه الناظر-إن شاء- صرف ذلك نقدا أو كسوة، أو طعاما أو غير ذلك، ومداواة المرضى”[33].
3-تعليمها وتزكية نفسها: وقد مر بنا كيف أنّ المساجد وحلقات العلم قد تكفلت بتعليم جميع المسلمين وتدريبهم على تزكية النفس، غير أنّ للأرملة خصوصية تتمثل في ضعفها، إذ فقدت السند والمعيل من جهة، وقد تُمارس عليها تحت أسر الحاجة الإغراءاتُ والضغوطات فتنحرف، فكان التعليم وممارسة العبادات لتزكية النفس ضرورة انتبه لها الواقفون على الأرامل والأيتام، ومن ذلك:
ما ذكره المقريزي في خططه حين أرّخ لرباط البغدادية”..وأدركنا هذا الرباط، وتودع فيه النساء اللاتي طلقن أو هجرن حتى تتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن صيانة لهن لما كان فيه من شدّة الضبط وغاية الاحتراز والمواظبة على وظائف العبادات..”[34].
4-التكفل ماديا ومعنويا بأيتامها: وهو ما يخفف العبء عليها، ويطمئنها ويدخل الفرح في قلبها، ومثاله:
– وقف صلاح الدين الأيوبي في أحد أبواب القلعة بدمشق ميزابا يسيل منه الحليب، وميزابا يسيل منه الماء المذاب فيه السكر، حيث تأتي إليهما الأمهات يومين في كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن ما يحتاجون من الحليب والشراب المحلى بالسكر[35]، والملاحظ هنا أنّ الأطفال جميعا يستفيدون من ذلك دون تفرقة بين فقير وغني، يتيم أو غير يتيم.
-نصت وثيقة وقف السلطان فرج على كسوة العرايا والمقلين، وستر عورات الضعفاء والعاجزين كسوة واقية من برد الشتاء، وحرّ الصيف، وإرضاع الأطفال عند فقد أمهاتهم أو عجزهن عن إرضاعهم وكفالتهم[36].
رابعا: نماذج من الوقف على الأيتام (وفيه رعاية للأرملة برعاية أيتامها):
لقد عرفت أوقاف كثيرة مخصصة للأيتام شملت كلّ ما يحتاجونه من مأكل ومشرب، وملبس ومأوى، وتعليم وتربية، وذلك شجع على كفالة الأيتام دون الحاجة إلى تبنيهم أو كتم أنسابهم، ومن ذلك:
-أنّ صلاح الدين أمر بعمارة مكاتب ألزمها معلمين لكتاب الله يعلمون أبناء الفقراء والأيتام خاصة، ويجري عليهم الجراية الكافية لهم.[37]
-جاء في ” الوقف في الفكر الإسلامي أن أبا الحسن المريني قد منح في نطاق الهبات العقارية الأيتامَ من سائر القبائل ما يسع حرث زوجين من الأرض.. فلا يقع بصرك على يتيم في بلاد المغرب إلا وهو مكفول..”[38].
1- وقف دور الأيتام:
إنّ رعاية الأيتام وتوفير كفايتهم من الطعام والشراب، واللباس والدواء والتعليم كانت مبكرة في تاريخ التجربة الوقفية الإسلامية، وقد أسهم في ذلك رجال المجتمع ونسائه، أمّا بناء الملاجئ والدور لاستقبال الأيتام واليتيمات فقد تأخر ذلك كثيرا[39]، وذلك لأنّ كفالة الأيتام كانت تتم عن طريق أواصر القرابة والرّحم، والرغبة في كفالة اليتيم كفالة كاملة بضمه إلى الأسرة، وكانت الأوقاف بما تنفقه على كل الأيتام الفقراء من غذاء وكساء ودواء وأدوات التعليم مع التعليم المجاني خير مشجع على ذلك ليسر نفقة اليتيم على الكافل مع ثبوت الأجر له على كفالته[40].
تكفلت الأوقاف بتأسيس دور الأيتام غير المكفول بهم لرعايتهم الشاملة بحفظ نفوسهم ماديا بتوفير الغذاء والشراب والمسكن والدواء، والأمن من كلّ اعتداء، ومعنويا بحسن تربيتهم وتنشئتهم وحفظ كرامتهم وصون أعراضهم.
والملاجئ أو الدور التي أسست كأوقاف ومُولَت بالأوقاف كثيرة، نختار نماذج منها[41]:
أ-جاء في حجة وقف المنشاوي الصادرة سنة 1903م تخصيص قطعة أرض لتكون تكية[42] ورباطا ومأوى وملجأ للعجزة واليتامى[43].
ب-ما خصصه سيد بك عبد المتعال من ريع وقفيته التي أنشأها في سنة 1920م لبناء ملجأ بمدينة سمود المصرية “يسع خمسين تلميذا من الأيتام، يتعلمون فيه التعليم المناسب لهم من الصناعة”[44].
ج-أنشأت السيدة جليلة طوسون[45] ملجأ لتربية ورعاية الفتيات اليتيمات ماديا ومعنويا وتربويا، يسمى هذا الملجأ (ملجأ الست جليلة)، وقد نصت في وقفيتها لسنة 1927 صرف عائد 138 فدان على الملجأ، وقد ضم الملجأ من خمسة عشر إلى عشرين طفلة يتيمة، تم اختيارهن وقفا لشروط نصت عليها الواقفة أهمها: ألاّ يكون لليتيمات عائل قادر على كفالتهن، واللطيمة التي فقدت والديها لها الأفضلية على اليتيمة التي بقى لها أحدهما.[46]
وقد اهتمت النساء الواقفات بإنشاء ملاجئ للبنين الأيتام أيضا، انطلاقا من هدف خدمة المجتمع والإنفاق على الخيرات والمبرّات[47].
2-التربية والتعليم:[48]:عن طريق وقف المساجد والكتاتيب والمدارس، والوقف عليها لاستمرار رسالتها التعليمية والتربوية[49] لقد أنشأت أوقاف المسلمين حكاما ومحكومين مساجد عامرة، وكتاتيب ملحقة بها لتعليم أطفال المسلمين ما يتعلق بأمور دينهم في معاشهم ومعادهم، وكانت هذه الكتاتيب عامة لجميع الأطفال وإن كان اليتامى والفقراء قد خُصوا بجرايات وعناية خاصة لحاجتهم وضعفهم[50]، أمّا المدارس العلمية فمنذ نشأتها ثم انتشارها في كافة بقاع الدولة الإسلامية منذ عهد نظام الملك السلجوقي في القرن الرابع للهجري[51]كانت بحق جامعات ومعاهد متخصصة لشتى العلوم الدينية والحياتية، النظرية والتطبيقية، متاحة لجميع الطلبة بما فيهم الأيتام.
3-توفير الغذاء والشراب والكساء والرعاية الصحية، والمنح النقدية وجبر الخواطر وإدخال السرور على نفوسهم في المناسبات:
جاء في وثيقة السلطان حسن لوقفه بأن يصرف ريعه في وجوه البرّ والقربات منها “.. إطعام الطعام، وتسبيل الماء العذب، والصدقة على الفقراء والمساكين والأيتام، والأرامل والمنقطعين، والزمنى والعميان وأرباب العاهات، وذوي الحاجات من أرباب البيوت وأبناء السبيل، على ما يراه الناظر-إن شاء-صرف ذلك نقدا أو كسوة، أو طعاما أو غير ذلك، ومداواة المرضى”[52].
كما جاء في وثيقة الأمير صرغتمش”..ويصرف في عيد الفطر من كلّ سنة مائتا درهم نقرة يشترى بها كعكا وتمرا وبندقا وخشكنانا، ويفرق ذلك على الأيتام ومؤدبهم والعريف على ما يراه الناظر في ذلك”[53].
وجاء في وثيقته أيضا”..ويصرف أيضا برسم الأيتام ومؤدبهم والعريف ثمن الحلوى في نصف شعبان، وفي أول شهر رجب من كلّ سنة مائة درهم واحدة وخمسين درهما نقرة، في كلّ وقت منهما خمسة وسبعين درهما نقرة..”[54].
أمّا وثيقة وقف السلطان قايتباي فقد نصت على “..ويصرف في كلّ سنة في شهر رمضان منها لكسوة العيد، وهو عيد الفطر للأيتام ومؤدبهم وعريفهم ما مبلغه من الفلوس الموصوفة أعلاه خمسة عشر ألف درهم.. “[55].
4-تزويج اليتيمات وتجهيزهن: لتحقيق مقصد حفظ العرض قامت الأوقاف بتوفير ما يلزم الشباب والشابات من نفقات الزواج وتيسيره لهم، منها توفير المهور لغير القادرين عليه، وتجهيز الفقيرات إلى أزواجهن تشجيعا على الزواج منهن، وتطييبا لخواطرهن، ومنها تجهيز بيوت وقفية بأثاثها لتقام فيها حفلات الزواج.
تحدث ابن بطوطة عن ذلك في رحلته قائلا ” .. والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها.. ومنها أوقاف تجهيز البنات إلى أزواجهن، وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن”[56].
جاء في كتاب ” الوقف في الفكر الإسلامي” ” ..كما كان وقف هام بالقطر التونسي خصص ريعه لتزويج بنات الفقراء واليتيمات “[57].
المحور الثاني: سبل تفعيل الوقف على الأرملة واليتيم في حياتنا المعاصرة
يشهد الوقف الإسلامي اهتماما رسميا من قبل الحكومات، وعلميا من قبل الباحثين والعلماء، ومجتمعيا بعد ظهور ما يُسمى بالمسؤولية المجتمعية ، فتوالت القوانين المنظمة لأحكام الوقف، وتتابعت المؤتمرات والبحوث والرسائل الجامعية التي تناولت الأوقاف وموضوعاتها، وكيفية إحياء نظمها، وتفعيلها في حياتنا المعاصرة لتسهم في حل مشكلاته خاصة ما تعلق منها بالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ورغم كل الجهود المبذولة إلا أنّ التغيير والتطوير والتفعيل يسير ببطء لا يتناسب مع حركة التطور السريع الذي يشهده العالم حاليا، وفيما يلي بعض الاقتراحات لتفعيل الوقف للتكفل برعاية الأرامل والأيتام في مجتمعاتنا المعاصرة:
1-نشر ثقافة الوقف في أوساط المجتمع، وتجديد الوعي بنظامه ومقاصده ومجالاته وآثاره على الفرد والأسرة والمجتمع والأمة[58].
2-إعادة إحياء الوقف الذري أو الأهلي، وتنظيمه وتيسير توثيقه، فالتكافل الأسري بالأرامل والأيتام في نطاق الأسرة الكبيرة أيسر وأدوم إذا كان عن طريق الوقف الأهلي[59]، ففيه مصلحة للفرد تتجلى في إضفاء الرضا والطمأنينة على نفسه ومسؤولياته، وفيه مصلحة للأسرة تتمثل في حفظ الفقير منهم لماء وجهه من ذل المسألة، وللعاجز منهم من مشقة الحاجة، وللمقطوعة والمردودة من النساء سلامة العيش، وفيه مصلحة للمجتمع تتجلى في إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي وكفاية المحتاجين والمعوزين[60].
3-تطوير قوانين الأوقاف بما يستجيب لمتغيرات العصر، لحل مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية، واستغلال الأوقاف الاستثمارية لإحداث تنمية مستدامة في المجتمعات الإسلامية، وتخصيص أوقاف نامية لرعاية الأرامل والأيتام.
4-تعديل القوانين المنظمة لعمل ونشاط الجمعيات الخيرية لتمكينها من إنشاء أوقاف خاصة بها[61]، تستثمرها وتنميها لإحداث استقلالية مالية تمكنها من رعاية الأرامل والأيتام رعاية كاملة شاملة للنواحي المادية والمعنوية، مع التركيز على تكوين الأسر المنتجة، لتمكين الأرملة من استثمار امكانياتها لإعالة نفسها وأسرتها، وتحقيق مشروعها الاقتصادي على أرض الواقع.
5-نشر التجارب الوقفية الناجحة لبعض الدول الإسلامية، والتي طورت بفضل الأوقاف أصناف رعايتها للأرامل والأيتام، كالتجربة الكويتية[62]، والمملكة السعودية، وتجربة الإمارات العربية المتحدة وتجارب الجمعيات الخيرية في دول الخليج ولبنان وغيرها.
الخاتمة:
نخلص في نهاية هذا البحث إلى النتائج التالية:
1-إحياء الوقف الإسلامي بكل أنواعه الذري والخيري، وتفعيله لرعاية الأرامل والأيتام أصبح ضرورة حتمية في ظل مشكلات العصر وضعف التكافل الأسري.
2-التكافل الاجتماعي ضرورة لتحقيق الأمن المجتمعي، والوقف أحسن وأنفع وأيسر آلياته.
3-الاهتمام برعاية الأرملة واليتيم والسعي لقضاء حوائجهم مما حض عليه الشرع الإسلامي، ورتب على فعله أجرا عظيما.
4-رعاية الأرملة والوقف عليها هو رعاية للأسرة وحماية للمجتمع.
5-رعاية الأيتام والوقف عليهم لسد حاجاتهم المادية والمعنوية هو رعاية لأيتام الحاضر رجال المستقبل وبُناته.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
[1]انظر: عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، تحقيق محمد محمد تامر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط1، 1426ه-2005م، ص228.
[2] حديث حسن صحيح، انظر: محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق حمد محمد شاكر وآخرون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، ط2، 1395ه-1975م، ج4، ص206.
[3] محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دار اليمامة، دمشق، ط5 ،1414ه-1993م، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج5، ص2032.
[4] محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الساعي على الأرملة، ج5، ص2237.
[5] الشاه ولي الله الدهلوي، حجة الله البالغة، تحقيق: السيد سابق، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط1، 1426ه-2005م، ج2 ص180.
[6] ابن قدامة موفق الدين المقدسي، المقنع، المؤسسة السعيدية، الرياض، مطابع الدجوي، القاهرة، ط3، 1980م، ج2، ص307.
[7] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم 1631، راجع: الإمام مسلم، الجامع الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ت، د ط، ج3، ص1255.
[8] وقد فسر العلماء “الصدقة الجارية “بأنها ” الوقف” لأنّ غيره من الصدقات لا يكون جاريا أي مستمرا على الدوام، راجع: ابن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج شرح المنهاج، تعليق محمد محمد تامر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ج2، ص595.
[9] حميد قهوي، دور الوقف في تفعيل مقاصد الشريعة، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ط1، 1436هـ-2015م، ص22.
[10] الوقف الذري هو اختراع إسلامي محض كما تقر بذلك موسوعة أمريكانا. راجع: منذر قحف، الوقف الإسلامي ,تطوره, إدارته، تنميته, دار الفكر, بيروت, دار الفكر دمشق,ط1 ،1421هـ-2000م، ص22.
[11] راجع: أحمد إبراهيم بك و واصل علاء الدين أحمد إبراهيم، موسوعة أحكام الوقف على المذاهب الأربعة، المكتبة الأزهرية للتراث ط1 ، 2009م ، ص265-266، عبد الوهاب خلاف، أحكام الوقف ، مطبعة النصر، القاهرة، ط3 ،1370هـ-1951م ، ص39-41.
[12] منذر قحف، الوقف الإسلامي، المرجع السابق، ص23.
[13]أبو بكر الخصاف، أحكام الأوقاف، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، دط، دت، ص11.
[14]كمال منصوري، الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف، رسالة دكتوراه، (غير منشورة)، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2009م، ص11، مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، دار الوراق والمكتب الإسلامي ،بيروت،ط1، 1420هـ-1999م ، ص194-268.
[15] د. محمد كمال الدين إمام، الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلامية، منشأة المعارف، الإسكندرية، دط، 2002،ص229.
[16] راجع : سليم هاني منصور، الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر،مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،ط1 ،1425هـ-2004م، ص41-160.
[17] سليم هاني منصور، الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر، المرجع نفسه، ص153-160، د. محمد محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1980م، ص178-231.
[18] لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “السَّاعِي علَى الأرْمَلَةِ والمِسْكِينِ، كالْمُجاهِدِ في سَبيلِ اللَّهِ، أَوْ: كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ”
[19] سليم هاني منصور، الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر، المرجع نفسه، ص41-59، محمد محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، المرجع نفسه، ص131-146.
[20] ابن جبير، رحلة ابن جبير، الأنيس موفم للنشر، الجزائر، دط، دت، ص255-258، أحمد عوف عبد الرحمن، أوقاف الرعاية الصحية في المجتمع الإسلامي، كتاب الأمة، قطر، ط1 , 1428 هـ-2007 م ، الكتاب كلّه يفصل في أوقاف الرعاية الصحيّة.
[21] ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر، بيروت ،لبنان، ط1 ،1424هـ-2004م،ص455 ، ابن جبير، رحلة ابن جبير، المصدر السابق، ص255-258، عبد الغني محمود عبد العاطي، التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك، دار المعارف، القاهرة،ط2 ،دت، ص48-159، محمد القطري، الجامعات الإسلامية ودورها في مسيرة الفكر التربوي، دار الفكر العربي، القاهرة،دط،دت،ص59-154.
[22]ابن جبير، رحلة ابن جبير، المصدر نفسه، ص281-282، سليم هاني منصور، الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر، المرجع السابق، ص 81-84، محمد محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، المرجع السابق،
ص 224-230.
[23]مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، المرجع السابق ، ص200-2004، منذر قحف ، الوقف الإسلامي، المرجع السابق، ص36-37، محمد محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، المرجع نفسه، ص 148-153.
[24] منذر قحف ، الوقف الإسلامي، المرجع نفسه، ص70-72 ، محمد محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية، المرجع نفسه، ص277-320.
[25]الخصاف، أحكام الأوقاف، المصدر السابق، ص5-16، برهان الدين الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، دط، 1401هـ-1981م، ص7-14.
[26] أي التي ترجع إلى بيت أبيها، وقد يكون ذلك من طلاق أو ترمل.
[27] الخصاف، أحكام الأوقاف، المصدر السابق، ص 11.
[28]الرباطات: أو الربط جمع الرباط، وهو في الأصل البناء المحصن الذي يقام قرب الحدود ويرابط به جماعة من المجاهدين لمهاجمة الأعداء، ودفع خطرهم ،وأكثر المسلمون من إقامة الربط على أطراف دولتهم، وكان أهل الرباط يجمعون بين حياة الجهاد والحياة الدينية، ولم يلبث انتشار التصوف أن خلق مبررا لبقاء الربط، فتحولت إلى دور للمتصوفة، وبالتالي أصبح الرباط يطلق على المكان الذي ينزل به المتصوفة، كما غلبت عليه صفة الملجأ، فأصبح ملجأ للمقعدين وأصحاب العاهات والأرامل والمطلقات، راجع: سعيد عاشور، المجتمع المصري، المرجع السابق، ص 186-187 .
[29]إيمان محمد الحميدان، المرأة والوقف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ط1، 1427هـ-2006م، ص 37.
[30] الخوانق أو الخانقوات مفردها خانقاه، وهي كلمة فارسية معناها بيت، وجعلت لتخلي الصوفية فيها للعبادة والتصوف، راجع: المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية، مكتبة الثقافة الإسلامية، القاهرة، دط ، دت، ج2، ص 114.
[31]سعيد عاشور، المجتمع المصري، المرجع السابق، ص 188.
[32] إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف السياسية، المرجع السابق، ص 312.
[33]محمد محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية، المرجع السابق، ص 134.
[34] المقريزي، الخطط، المصدر السابق، ج2، ص 428، محمد محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية المرجع نفسه، ص 139.
[35]مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، المصدر السابق، ص 203.
[36]محمد محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية، المرجع السابق، ص 135.
[37] ابن جبير، رحلة ابن جبير، المصدر السابق، ص 21.
[38] بنعبد الله، الوقف في الفكر الإسلامي، المرجع السابق، ح1، ص 136.
[39]لم نحصل على معلومات دقيقة عن بداية بناء دور وملاجئ للأيتام، جلّ ما وجدناه أنّه في عهد نور الدين بن زنكي، أنشأ هذا الأخير دورا للأيتام، وهذا معقول جدا خاصة مع الحروب الصليبية واعتداءاتهم على كثير من المدن الشامية والمصرية وقتلهم المدنيين دون استثناء، فنشأ عن ذلك أعداد كثيرة من الأيتام، راجع تفصيل ذلك: محمد كرد علي، خطط الشام، مكتبة النوري، دمشق، ط2، دت، ج3، ص 43، علي الصلابي، نور الدين القائد المجاهد زنكي، مؤسسة اقرأ، القاهرة، ط1، 1428هـ-2007م، ص 141.
[40]وذلك بنص الحديث النبويّ «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى» أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيما، راجع: صحيح البخاري، المصدر السابق، مج4، ص326.
[41]راجع تفصيل ذلك: محمد محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية، المرجع السابق، ص 132 وما بعدها، إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف السياسية، دار الشروق، القاهرة، ط1 ،1419ه- 1998م، ص 312-313، إيمان محمد الحميدان، المرأة والوقف، المرجع السابق، ص 39، ريهام خفاجي، أوقاف النساء- نماذج لمشاركة المرأة في النهضة الحضارية-مجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت- العدد 4، 2003،ص22.
[42]التكية: مفردة التكايا، فقد كانت مؤسسة متعددة الأغراض، فأحيانا لاستضافة الغرباء والمسافرين، وتارة لإيواء الفقراء والمساكين، وتارة أخرى لإقامة طلبة العلم أو الدراويش الصوفية، ولهذا لم يمكن تصنيفها ضمن مؤسسات الخدمة العامة أو الرعاية الاجتماعية لبعض الفئات الخاصة، وإنما هي في هذا وفي ذاك، انظر:إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة، المرجع نفسه، ص 291.
[43]إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة، المرجع نفسه، ص 312.
[44]إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة، المرجع نفسه، ص 313.
[45]السيدة جليلة طوسون هي حرم أحمد زكي باشا الأديب المعروف، والملقب بشيخ العروبة، وقد أوقف هو أيضا مكتبته الضخمة في قبة الغوري، راجع: إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة، المرجع نفسه، هامش ص 313.
[46]إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة، المرجع نفسه، هامش ص 313، ريهام خفاجي، أوقاف النساء، المرجع السابق، ص 22، إيمان الحميدان، المرأة والوقف، المرجع السابق، ص 39.
[47]إيمان الحميدان، المرأة والوقف، المرجع نفسه، ص 39.
[48]راجع: أحمد فكري، مساجد القاهرة ومدارسها، المرجع السابق، ج2، ص135- 144. عبد الغني عبد العاطي، التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك، القاهرة, دت, ط2، دت، ص 75-155.
[49] راجع: حياة عبيد، أحكام الوقف ودوره في تشجيع وترقية البحث العلمي-أطروحة دكتوراه غير منشورة-(جامعة وهران بالجزائر، 2014م)، ص325-403، رابط الأطروحة: [https://theses.univ-oran1.dz/thesear.php?id=61201445t].
[50]عبد الغني عبد العاطي، التعليم في مصر، المرجع السابق، ص 91.
[51]راجع: عبد الهادي محمد رضا محبوبة، نظام الملك، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط1، 1419م، ص 353-355.
[52]محمد محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية، المرجع السابق، ص 134.
[53] محمد محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية، المرجع السابق، ص 142-143 وراجع أمثلة أخرى في نفس المرجع، ص 139-148.
[54]محمد محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية، المرجع نفسه، ص 145.
[55]محمد محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية، المرجع نفسه، ص 146.
[56] ابن بطوطة، تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن بطوطة )، تحقيق طلال حرب، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، د ت ،ج1 ص 75.
[57] بن عبد الله، الوقف في الفكر الإسلامي، منشورات وزارة الشؤون والأوقاف الإسلامية، المملكة المغربية، دط، 1416هـ-1996م، ج1 ص 140.
[58] راجع: إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، دار البشير للثقافة والعلوم، مصر، ط1، 1437ه-2016م
[59] جمعة محمود الزريقي، الوقف الأهلي بين الإلغاء والإبقاء، مجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، العدد 3، رمضان 1423هـ-2002م، ص 99-100.
[60]إبراهيم محمود عبد الباقي، دور الوقف في تنمية المجتمع المدني، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ط1 ، 1427ه-2006م، ص44.
[61] إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، المرجع السابق، ص230.
[62] إيمان محمد الحميدان، المرأة والوقف، المرجع السابق، ص69.